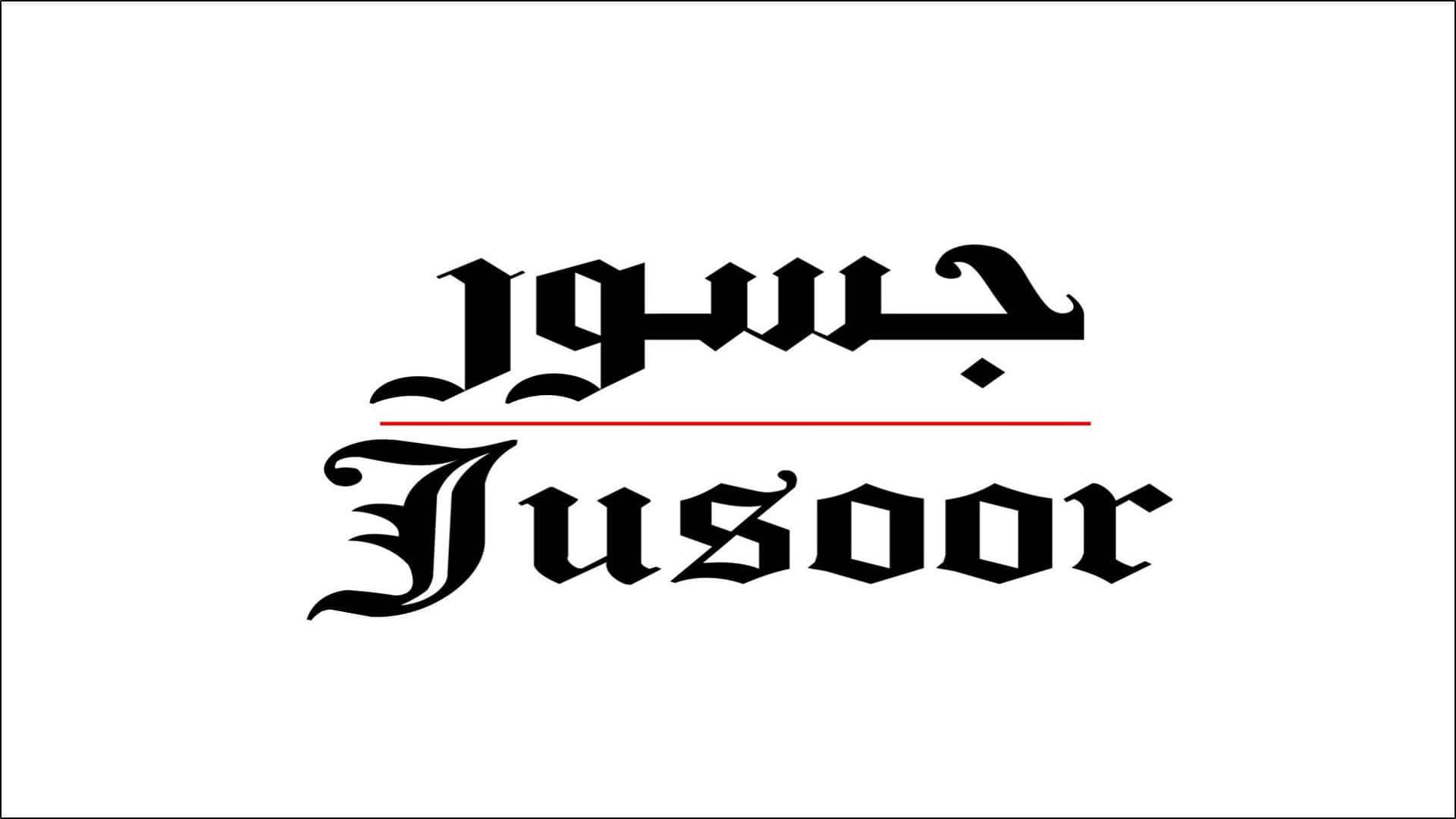على حافة الخرائط.. معاناة نساء المناطق الحدودية بين جغرافيا قاسية وتجاهل متعمد
على حافة الخرائط.. معاناة نساء المناطق الحدودية بين جغرافيا قاسية وتجاهل متعمد
في أقصى الشمال الغربي من مصر، بقرية بقيق على الحدود مع ليبيا، تقف زينب (اسم مستعار) سيدة في الأربعين من عمرها، أمام فرن طيني تُعد فيه الخبز لأولادها الستة، حيث لا يوجد مستشفى قريب، أو مدرسة جاهزة، أو مركز خدمات حكومي متكامل.
يقولون في الأعراف القبلية إن الحدود حامية لسكانها، كأنها درع يصد المخاطر أو سياج يمنح الأمان، لكنها برأي زينب، مجرد خط أصم وأعمى لا يسمع صرخات الاستغاثة ولا يرى دموع المنكوبين، خط جاف يعزل بين أحلام مشروعة بالحياة وواقع شديد القسوة والجفوة.
تسرد زينب أحد فصول مأساتها لـ"جسور بوست" قائلة: "ماتت ابنتي ذات الثلاث سنوات عندما ارتفعت حرارتها فجأة، ولم نجد سيارة تنقلنا إلى المستشفى في سيوة، كنا في منتصف الليل، والمسافة طويلة، والطرق وعرة وغير ممهدة، والهاتف لا توجد به شبكة".
حاولت زينب إسعاف صغيرتها بالطرق التقليدية الشعبية طوال الليل، وضعت الكمادات، وقرأت ما تحفظه من آيات، وأشعلت نارًا خفيفة قرب جسدها المتعب، علّها تخفف وطأة الحمى، لكنها لم تقوَ على الوصول بها إلى بر الأمان، وفي لحظة ثقيلة احتضنت ابنتها بقوة كأنها تريد أن تنقل إليها الحياة، لكنها شعرت ببرودة أطرافها.
تقول زينب بنبرة اعتادت الوجع: "لم يكن بيدي شيء أفعله غير البكاء، فأصواتنا لا تصل لأحد مهما صرخنا.. نعيش ونموت هنا في صمت، لا طبيب، ولا طريق، ولا مسؤول، ولا أحد يسأل عنا".
ليبيا الجريحة
لم تكن زينب هي البطلة الوحيدة في مسلسل معاناة النساء في المناطق الحدودية، فعلى بُعد مئات الكيلومترات، في بلدة غات الليبية القريبة من الجزائر، تعيش أم الخير، أرملة شابة تربي 3 أطفال في بيئة صحراوية شحيحة الموارد، بعد سقوط زوجها في اشتباكات قبلية، أصبحت هي المعيل الوحيد، تبيع الحرف اليدوية للسياح، الذين باتوا نادرين بسبب انعدام الأمن في بلادها.
تحلم أم الخير، السيدة الليبية الثلاثينية التي تعيش في ضواحي غات قرب الحدود الجزائرية، بتعليم ابنيها الصغيرين، وأن تراهما يرتديان زي المدرسة ويحملان الدفاتر والأقلام، بدلًا من العمل في جمع الحطب، لكن الفقر ومحدودية الموارد يسبقهما إلى حيث لا تريد الأم المغلوبة على أمرها إلى عالم قاسٍ لا يشفق على طفولتهما.
أما ابنتها "سمية"، ذات الخمس سنوات، فتعاني من مرض تنفسي مزمن سببه الغبار والأتربة المنتشرة في هواء الصحراء الجافة، حيث لا توجد رقابة بيئية، أو حتى وحدة صحية قريبة، وتقول أم الخير لـ"جسور بوست": "كل ليلة بنتي تتنهج بصوت عالٍ، وما نلقاش البخاخ، ولا في سيارة تودّيني للمركز في أوباري. مرات نفتح الباب باش يدخل هوا نقي، لكن الهوا كله تراب".
تصمت قليلا قبل أن تضيف: "ما نبيش (لا أريد) حاجة كبيرة.. بس نبي (نريد) نودي بنتي للطبيب من غير ما نحتاج واسطة، ولا نستنى بالأيام لين (حتى) تمر علينا سيارة".
المغرب والجزائر
في الحدود المغربية الجزائرية المغلقة منذ عقود، تقيم مليكة في قرية "بني درار" المغربية، إذ تعاني عزلة مضاعفة، فهي لم تر شقيقتها المقيمة في الجزائر منذ أكثر من 20 عاما، رغم أن المسافة بينهما لا تتجاوز بضعة كيلومترات.
ومزقت التوترات السياسية، العلاقات الأسرية بين سكان القرى في البلدين، حيث أضحت جرحًا نازفًا في قلب مليكة، التي اعتادت إرسال الهدايا مع المهربين، وتلقي أخبار أختها عبر منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة بائسة لترميم شتات الحنين العائلي.
وفي أعماق المناطق الحدودية والمهمشة في المغرب العربي، لا تعيش المرأة فقط على هامش الجغرافيا، بل على هامش الاهتمام السياسي والتنموي أيضا، فالمرأة في هذه المناطق ليست مجرد ضحية لفقر مزمن أو بعد عن المراكز الحضرية، بل ضحية صراع يومي بين قسوة الطبيعة وتجاهل السياسات المركزية.
فما بين البنية التحتية المهترئة، وغياب الخدمات الصحية والتعليمية، وانعدام شبكات الطرق، وقوانين العبور الصارمة تتحول الحدود إلى جدران صامتة بدلًا من أن تكون جسورًا للتبادل والنمو، وفي قلب هذا المشهد، يتطلب من النساء أدوار جسيمة كالأم والممرضة والمعلمة والمزارعة، بل والدرع الواقي في وجه الجوع والعنف بهذه المناطق الوعرة.
ومن قلب الصحاري إلى قمم الجبال، ومن قرى الحدود الليبية إلى التلال المغربية، تتجلى نساء الهامش كأيقونات صبر وقوة وتحمل، إنهن لا يطلبن المستحيل، فقط باتت كل أحلامهن تنحصر في وجود دولة تتذكر أنهن مواطنات، وحدود لا تكون سجناً، بل جسرًا للتنمية والكرامة.
معاناة النساء
رغم اعترافها بأن أوضاع النساء في المناطق الحدودية بمصر شهدت "تحسنًا نسبيًا" خلال السنوات الخمس الأخيرة، ترى فاطمة عثمان، وهي رائدة صحراوية تقيم في قرية "سيرة" الواقعة في أقصى غرب مصر، أن الطريق لا يزال طويلاً نحو تمكين النساء، خاصة في القرى النائية بالمناطق الحدودية.
"أكبر تحد نواجهه هو بُعد ومحدودية الخدمات الصحية، وعدم توافرها للفتيات بالشكل الكافي بسبب العادات والتقاليد"، تقول فاطمة في اتصال هاتفي مع “جسور بوست”، مضيفة: "التعليم أفضل حالًا نسبيًا، لكنه يظل مرهونًا بوعي ومرونة الأسر. هناك من تسمح لبناتها باستكمال التعليم، وهناك من تكتفي بالمرحلة الإعدادية خوفًا من بُعد المدارس الثانوية أو قلة المواصلات الآمنة".
ورغم هذا التباين، تؤكد فاطمة أن العادات والأعراف لا تزال اللاعب الأساسي في رسم ملامح حياة النساء في المناطق الحدودية: "الكثير من النساء لديها طموح، لكن المجتمع ما زال يحدد دورها داخل حدود الزواج والمنزل فقط، حتى من ترغب في العمل أو إقامة مشروع، غالبًا ما يكون داخل البيت، وليس خارجه".
وفيما تنفي وجود عنف أسري ممنهج ضد النساء في واحة سيوة، نظراً لطبيعة الأعراف القبلية التي تحكم العلاقات الاجتماعية، تلفت فاطمة إلى أن النساء هن الأكثر تضررًا من الظروف البيئية والاقتصادية: "قلة المواصلات، وصعوبة التنقل، وندرة المياه، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب الظروف المناخية القاسية، جميعها كلها تحديات تثقل كاهل النساء في مناطقنا".
وعن دور الدولة والمنظمات الأهلية بشأن حقوق المرأة، تعتبر فاطمة أن الدعم لا يزال ضعيفًا ومحدودًا للغاية: "تُقام أحيانًا دورات تدريبية لتعليم الحرف اليدوية أو رفع الوعي، لكنها غالبًا ما تكون موسمية ولا تضمن الاستمرارية، وبالتالي لا تحقق نتائج مستدامة يمكن البناء عليها لتحسين أوضاع النساء بشكل حقيقي".
ورغم التحديات التي تواجهها النساء في المناطق الحدودية عربيا، تقدم المرأة نموذجا في خوض المعارك اليومية الصامتة من أجل الكرامة والحق في التعليم والرعاية وفرص العمل، أملا في الحصول على فرص عادلة ودعم مستدام يُخرج أحلام النساء من جدران البيوت إلى فضاء أوسع من المشاركة والحياة.